مذكرات كاتب قبيض

نعم، سأقولها كما يتمنّى البعض أن يسمعها منذ سنوات. لن أختبئ خلف الكلمات بعد اليوم، ولن أدور حول الموضوع.
نعم… سأعترف: أنا أقبض.
وليس فقط أقبض، بل أتقاضى أجرًا ثابتًا على كل مرة أكتب فيها رأيًا لا يشبه الصوت العالي، وفي كل مرة أحاول فيها رؤية الصورة كما هي بينما يفضّل البعض الجري خلف موجة يعرفون اتجاهها ولا يعرفون نهايتها.
ما أتقاضاه فعليًا ليس مالًا، ولا امتيازًا، ولا منصبًا، بل شيء واحد فقط: الهجوم.
أقبض شتائم بدل الرواتب، وتشكيك بدل الزيادات، واتهامات بدل المكافآت.
كل ما في الأمر أنني كلما كتبت رأيًا بعقلي، دفعوا لي حصتي من الظنون.
وكلما حاولت قول الحقيقة بهدوء، استلمت حصتي من الشتائم الجاهزة.
وهذه هي الدفعات الشهرية التي تصلني دون انقطاع.
في البحرين صار من الطبيعي أن تُتَّهم قبل أن تُفهَم، وأن تُفحَص نواياك قبل أن تُقرأ أفكارك، حتى بدا كأن خلف كل رأي متزن حسابًا خفيًا، وكأن كل كلمة هادئة تقف وراءها خزينة مفتوحة. يكفي أن تقول جملة لا توافق المزاج العام لتُسدَّد في وجهك تهمة التمويل، ويكفي أن تدافع عن قرار منطقي ليُقَيَّد اسمك في قائمة “المدفوعين”، كأن فكرة الوطن لا تمشي وحدها بدون وصل تحويل.
المشكلة أن من يكررون السؤال نفسه لا يميزون بين الرأي والولاء، ولا بين النقد والخصومة.
عندهم كل اختلاف تواطؤ، وكل حياد انحياز، وكل محاولة للتهدئة خيانة متنكرة.
لا يتصورون أن أحدًا يمكن أن يتكلم من نفسه، لأنهم ببساطة لم يعتادوا أن يفكروا من دون توجيه.
لذلك يتحول حب الوطن إلى تهمة سهلة، ويصبح التفكير الهادئ دليل إدانة بدل أن يكون فضيلة.
والغريب أن أكثر من يرفعون شعار “حرية الرأي” هم أسرع الناس إلى مصادرتها حين لا تعكس وجوههم.
يريدون حرية على مقاسهم، حرية لا تقبل إلا صوتًا يشبه صوتهم، ولا تحتمل رأيًا يقف خارج دائرة رضاهم. يريدونك أن تغضب حين يغضبون، وأن تهتف حين يهتفون، وأن تصمت حين يصمتون. فإن خرجت عن الإيقاع قيل إنك قبضت، حتى لو لم تقبض سوى خيبتك.
وعلى هذا المنهج تتحول الوطنية إلى بطاقة عضوية يوزعونها على من يردد كلماتهم ويسحبونها ممن يقف في منتصف الطريق، كأن الوطن شركة خاصة لها بوابة وحارس وتعليمات دخول.
على هذا المنهج يصبح السؤال الحقيقي ليس “كم دُفع لك؟” بل:
كم دفعت أنت من نفسك كي تصل إلى هذه الدرجة من الشك؟
كم مرة سبقت الكراهيةُ التفكيرَ؟ وكم مرة فقدت الثقة قبل أن تسمع؟
لأن من يرى المؤامرة في كل زاوية يعيش متعبًا مهما ظن أنه يقِظ.
ينام على وسادة من الظنون، ويستيقظ على رائحة خيانة، ويستبدل مناقشة الأفكار بتفتيش النوايا، ويستسهل اتهام البشر بدل أن يتعب نفسه في فهم الحجج.
ولا أستغرب أن يترسخ هذا المزاج؛ فالتعبئة المستمرة تصنع وعيًا يرى اليد الخفية في كل كلمة، ويتعامل مع أي محاولة إصلاح كأنها فخ، ومع أي رأي متزن كأنه صفقة، ومع كل صاحب رأي كأنه موظف لا يعرف حتى عنوان المؤسسة التي يعمل بها. ومع الوقت يصبح الاتهام عادة، ويصبح الشك يقينًا، وتتآكل القدرة على الإصغاء، ثم ينتهي بنا الأمر إلى سوق صاخبة تُباع فيها صكوك الوطنية بالتجزئة، ويتحوّل النقاش العام إلى مزاد لا يبحث عن الحقيقة بل عن الفائز في جولة الصراخ.
ولأنني كتبت هذا المقال، فأنا الآن جالس في مكتبي الفخم، أرتشف قهوتي المستوردة، أراجع في هاتفي إشعارات التحويل التي لم تصل بعد.
أنتظر أن يُطرق الباب في أي لحظة. يدخل رجل ببدلة رسمية، يسلّمني الظرف الأبيض بابتسامة واثقة، ثم ينسحب تاركًا خلفه أثر سيجار كوبي فاخر يملأ الغرفة.
أطفئ السيجار بهدوء، أفتح الظرف، أعدّ الأوراق، أبتسم، وأقول لنفسي:
“أخيرًا… وصل الدفع.”
وغدًا حين يمر هذا النص أمام الذين لا يصدقون شيئًا غير ما يشبه غضبهم، سيكتب بعضهم الجملة ذاتها التي لا تتغير:
“أكيد قبض.”
وسأبتسم… ليس لأنهم أصابوا الحقيقة، بل لأن خيالهم أخيرًا وجد مكانه الطبيعي داخل قصة كتبتها أنا، لا هم.
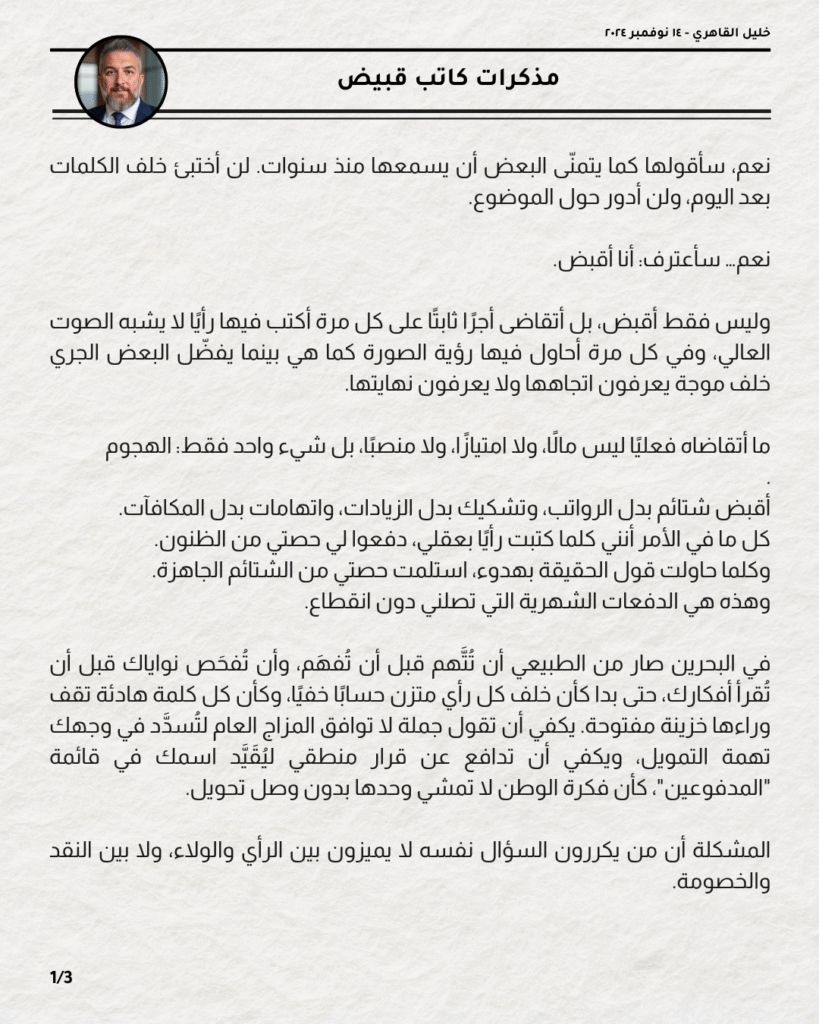
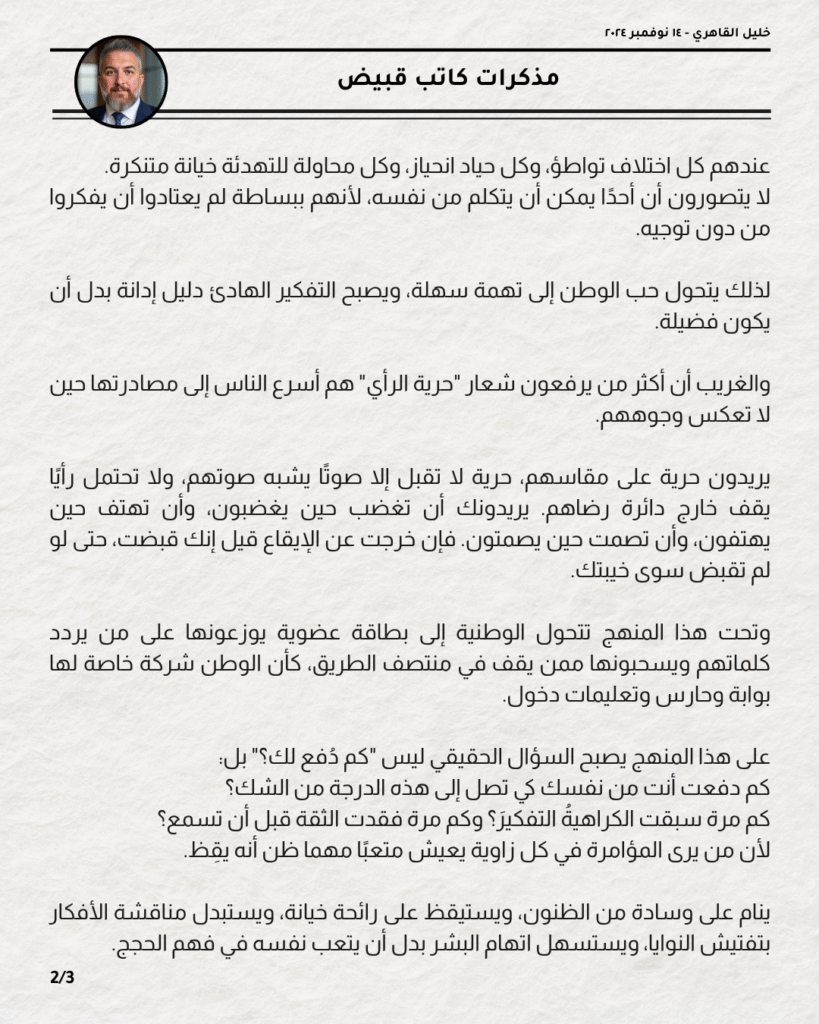
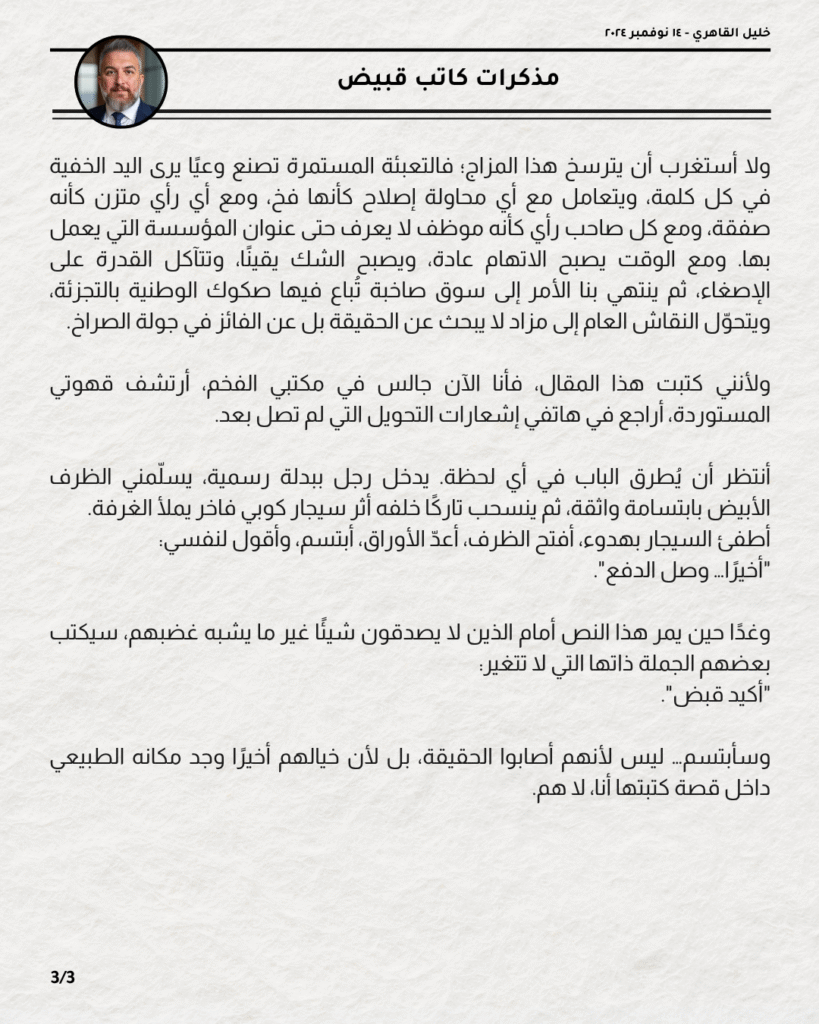





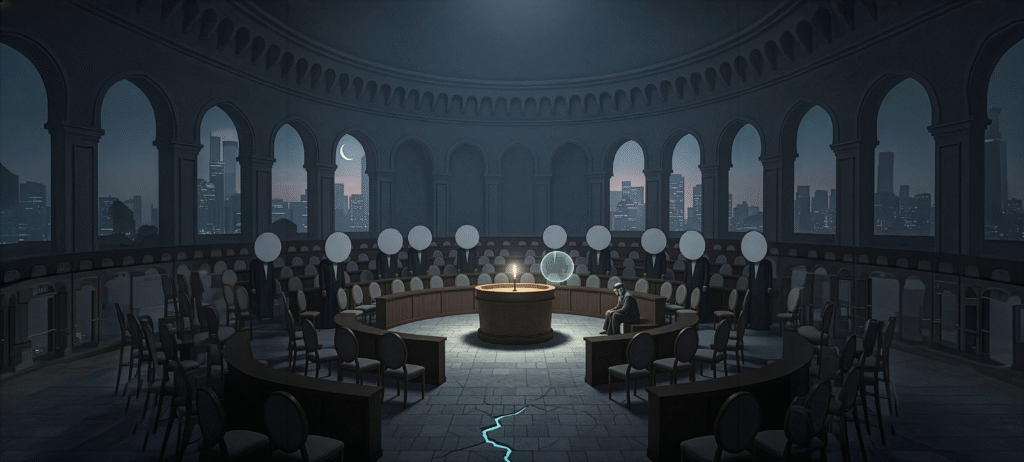
Responses