قانون العزل السياسي

سلسلة ماذا لوكنت نائباً؟ (١)
منذ صدوره في 2018، بقي قانون العزل السياسي حاضرًا في النقاش العام. ليس لأنه يحدد فقط من يحق له الترشح، بل لأنه لامس معنى المشاركة السياسية والحق المدني في أبسط صورها، أن تكون قادرًا على المشاركة أو غير قادر بسبب انتماء سابق. البعض يرى أن القانون جاء كحاجة مرحلية لضبط المشهد بعد سنوات صعبة، والبعض الآخر يرى أنه أنتج آثارًا جانبية تستحق الوقوف عندها بهدوء.
لماذا صدر القانون أصلًا؟
لفهم القانون لا يكفي قراءة نصه بل يجب فهم اللحظة التي وُلِد فيها. البحرين في تلك السنوات لم تكن تعيش مرحلة عادية، كانت تخرج تدريجيًا من مرحلة توتر سياسي واجتماعي. وكان التحدي الأكبر هو حماية المجتمع من العودة إلى دوائر الاستقطاب أو إعادة إنتاج نفس الديناميكيات التي سبقت الأزمة. لذلك اتجهت الدولة نحو ما يمكن تسميته بـ”التحصين الوقائي” للمشهد السياسي، وهو نهج مفهوم حين يكون الهدف الأول هو تثبيت الاستقرار وضبط الإيقاع العام.
في تلك اللحظة، لم يكن السؤال: “هل هذا القانون مثالي؟” بل كان: “هل يمنع تكرار سيناريو قد يهدد الاستقرار مرة أخرى؟” ولذلك بدا القانون وقتها منطقيًا ومناسبًا للسياق.
حين تتغير المراحل: هل يجب أن يتغير القانون؟
مرور الوقت وضع القانون في سياق مختلف عمّا كان عليه يوم صدوره. فالمشهد السياسي والاجتماعي اليوم أكثر استقرارًا، والمساحات المتاحة للنقاش أهدأ مما كانت عليه في السنوات الأولى. ومع تغيّر الظروف تتغيّر أيضًا الأدوات المناسبة لإدارة المشاركة السياسية. وهذا يجعل السؤال حول القانون ليس تحديًا له أو رفضًا لوجوده، بل محاولة لفهم ما إذا كان ما زال يؤدي الدور الذي وُضع لأجله، أو أن المرحلة الحالية تحتاج معالجة أكثر دقة في تطبيقه بدل الإبقاء عليه بصيغته الشاملة.
النقطة هنا ليست في التشكيك في جدوى القانون عند صدوره، بل في الاعتراف أن التشريعات ـ مثلها مثل الواقع نفسه ـ تمر بمراحل مراجعة وتطوير. فالقانون الذي صُمم لحماية المجتمع من احتمالية العودة إلى أجواء الانقسام قد يصبح، في مرحلة أكثر استقرارًا، بحاجة لآليات تسمح بالتمييز بين الحالات، وتوفير مسارات قانونية منظمة لإعادة التأهيل، دون المساس بمبادئ الدولة ولا بالغاية الكبرى من حفظ الاستقرار. بهذا الفهم يصبح النقاش حول القانون خطوة ضمن تطور طبيعي للتشريع، لا عودة للنقاشات القديمة ولا محاولة لفتح ملفات انتهت، بل استجابة لتغير الزمن وظروفه ومتطلباته.
من تأثر بالقانون… وهل كان الجميع في نفس الخانة؟
تطبيق القانون شمل كل من كان جزءًا من الجمعيات المنحلة، لكن التجربة الواقعية لمن شملهم القانون لم تكن واحدة. فهناك من كان في موقع صنع القرار أو التأثير المباشر، وهناك من كان مجرد عضو أو متابع لم يشارك فعليًا في اتخاذ مواقف أو إدارة توجهات، بل دخل التجربة بدافع البحث عن فهم سياسي، أو انتماء فكري، أو رغبة طبيعية في المشاركة العامة، ثم ابتعد لاحقًا أو غيّر موقفه بالكامل مع مرور الزمن وتحول الظروف. وبين هذه الفئات ظهر طيف واسع من التجارب: أشخاص راجعوا قناعاتهم، وآخرون طوروا فهمهم، وبعضهم أصبح أكثر التزامًا بثقافة الدولة والقانون بعد التجربة وليس قبلها.
هذا التباين في المسارات الفردية يجعل استمرار التصنيف الشامل كما هو خطوة لا تعكس الواقع الحالي ولا تستثمر ما يمكن أن يتحول إلى إضافة إيجابية للدولة والمجتمع. فالتشريعات ليست فقط أدوات ضبط، بل أيضًا أدوات توازن، ومن الطبيعي أن يُعاد النظر فيها عندما يتغير الواقع وتتغير مواقف الأشخاص الذين خضعوا لها.
جيل يفكر مرتين قبل المشاركة
أثر القانون لم يتوقف عند من شملهم، بل امتد إلى الجيل الجديد الذي لم يكن طرفًا في تلك المرحلة. بالنسبة للكثير من الشباب، أصبحت المشاركة في أي إطار مدني أو سياسي خطوة محسوبة لا خيارًا طبيعيًا كما يفترض أن تكون في دولة تراهن على المشاركة الواعية. مجرد التفكير في الانضمام لنشاط جماعي أو جمعية مسجلة قد يبدو للبعض مخاطرة مستقبلية، فيتحول العمل العام من مساحة اكتشاف وتجربة إلى مساحة يتحاشاها الكثيرون.
هذا التحول الصامت لا يظهر مباشرة في المؤشرات، لكنه يظهر في المزاج العام. فبدل أن تتشكل القيادات من التجربة، والحوار، والاحتكاك العملي، أصبح كثير من الشباب يتابع المشهد من الخارج دون رغبة في الانخراط فيه. ومع مرور الوقت يتكوّن فراغ بين الحياة العامة والجيل الذي يفترض أن يحملها مستقبلًا. الثقافة السياسية لا تُورث نصًا ولا تُلقّن نظريًا، بل تُبنى من الاحتكاك والممارسة والتدرّب على الاختلاف داخل أطر منظمة. وكلما ضاقت مساحات المشاركة، زادت المسافة بين الجيل الجديد والعمل العام، وهذا ما يستحق الالتفات إليه كجزء من قراءة الصورة المستقبلية وليس فقط تقييم الماضي.
نظام يُعيد أبناءه لا يستبعدهم
التجربة السياسية في البحرين، عبر عقود طويلة، أثبتت أنها لا تؤمن بسياسة “الباب المغلق”. الدولة في معظم اللحظات المفصلية اختارت طريق الاستيعاب التدريجي لا الإقصاء الدائم. والدليل الأوضح كان ما حدث في 2002 حين عاد الجميع للمشاركة دون استثناء. هذه الطريقة لم تكن قرارًا عابرًا، بل تعبيرًا عن طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع: علاقة قائمة على القرب، وعلى فكرة أن الاختلاف ظرفي، بينما الانتماء ثابت وطويل المدى. هذه المرونة ليست ضعفًا بل قوة ناعمة بنت علاقة خاصة بين الشعب والدولة، علاقة فيها مساحة للعودة بعد الخطأ، وللنضج بعد التجربة.
ماذا لو كنت نائبًا؟
لو كنت نائبًا اليوم لن أتعامل مع القانون بمنطق “إلغاء أو استمرار”، بل بمنطق ثالث: التعديل الذكي التدريجي، الذي يحافظ على منطق القانون وأهدافه لكنه يمنح النظام آلية عادلة لتقييم الحالات بشكل فردي لا جماعي، وبناء مسار سياسي صحي أكثر انفتاحًا وتوازنًا.
كنت سأتعامل مع هذا الملف بثلاث مبادئ:
- الاعتراف بأن القانون جاء لظرف محدد
- عدم نفي حاجته حين صدر
- التعامل معه اليوم بعيون مرحلة مختلفة
وكنت سأطرح مقاربة تشريعية متدرجة لا تلغي القانون ولا تعيد الوضع كما كان، بل تُنشئ آلية عادلة ومُنظمة لإعادة النظر:
- اعتماد معيار واضح يقيس الجدارة بناءً على السلوك الحالي، والاستقرار القانوني، وعدم ارتباط الفرد بأي ملفات أو إجراءات قضائية مفتوحة أو عالقة تتصل بالمرحلة التي صدر فيها القانون. الهدف من هذا الشرط ليس الإدانة أو إعادة المحاسبة، بل ضمان أن من يعود للحياة السياسية يعود من موقع مستقر قانونيًا وواضح في موقفه من العمل الوطني.
- تحديد فترة انتقالية زمنية واضحة لمن تمت الموافقة على مشاركته، يبدأ خلالها بالمشاركة المدنية والمؤسسية قبل الانتقال للترشح أو تولي مواقع تمثيلية.
- اشتراط مساهمة ملموسة في خدمة عامة أو مشروع وطني يعكس الاستعداد العملي للمسؤولية، ويعيد بناء الجسر بين المشاركة السياسية والمصلحة العامة.
- توفير برنامج تأهيل سياسي وقانوني للراغبين في العودة، يركز على فهم الأطر الدستورية، وآلية صنع القرار، وأخلاقيات العمل العام، لضمان مشاركة أكثر استعدادًا ونضجًا.
هذه الأدوات ليست تنازلات بل أدوات توافقية تحترم هيبة الدولة وتحترم المجتمع في الوقت نفسه.
خطوة أولى في طريق أطول
في النهاية، ليست القوانين وحدها ما يصنع شكل الحياة السياسية، بل الطريقة التي نتعامل معها، وكيف نسمح لها بأن تتطور معنا لا أن تبقى ثابتة بينما الواقع يتحرك. هذا الملف ليس صراعًا بين من مع ومن ضد، بل مساحة اختبار لقدرتنا على الانتقال من معالجة مرحلة حساسة إلى بناء مرحلة أكثر نضجًا واتزانًا. وإن كانت هذه السلسلة محاولة لفهم ما يمكن أن أقدمه لو كنت يومًا تحت قبة البرلمان، فإن هذا المقال هو بدايتها، لا خلاصة موقف. وما يأتي بعده ليس بحثًا عن إجابات مثالية، بل عن أسئلة تُفتح بصوت هادئ ووعي مسؤول، لأن التشريع ليس نصًا فقط… بل رؤية لما يجب أن يكون.



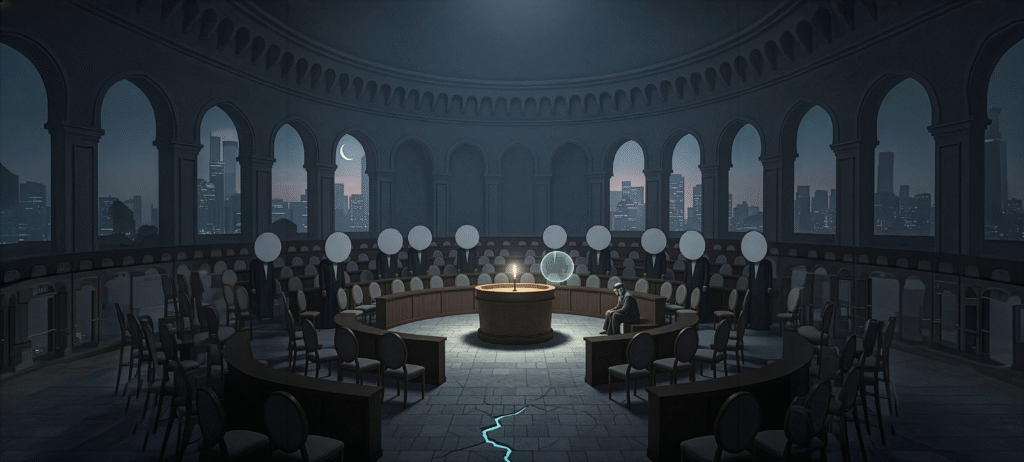


Responses